أصدر الروائي رشيد الضعيف رواية جديدة بعنوان “الوجه الآخر للظل” (دار الساقي)، بعد أكثر من عشرين رواية، وثلاث مجموعات شعرية، ومجموعة قصصية واحدة. والضعيف من أبرز الأسماء في الحركة الروائية اللبنانية والعربية، ترجمت أعمال عدة له إلى الفرنسية والإنجليزية وسواهما، وقدمت عن رواياته أطروحات أكاديمية، بالعربية والفرنسية. وفي مناسبة صدور الرواية الجديدة، هنا حوار معه عن تجربته عموماً ومعظم أعماله، وعن أهم شواغله الفكرية وموضوعاته، وخصائص أسلوبه، بالإضافة إلى آرائه في ما خص الرواية الأخيرة ونوعها الأدبي، وتناصها مع غيرها من الأعمال السردية في التراث العربي والأجنبي.
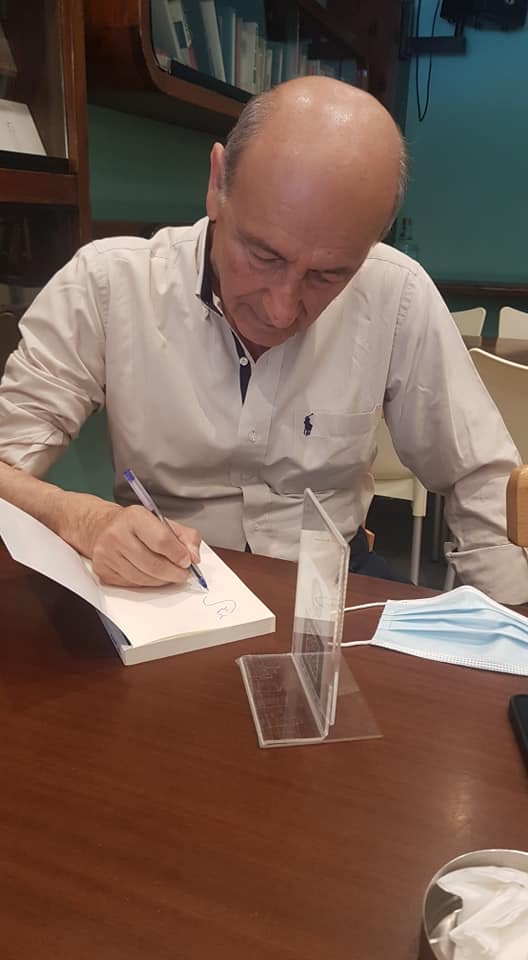
في روايته الجديدة “الوجه الآخر للظل” يدخل عالم السرد الخيالي الفانتازي
أسأل رشيد الضعيف عن كونه بدأ شاعراً، وأصدر ثلاث مجموعات شعرية هي “حين حل السيف على الصيف”، و”لا شيء يفوق الوصف”، و”أي ثلج يهبط بسلام”، ثم سرعان ما انتقل إلى كتابة الرواية، فيجيب: “كان ثمة ترحيب كبير بكتابتي الشعرية، حين صدور المجموعات الشعرية هذه، ولكن لا يسع المرء أن يعصى نداءه الداخلي إلى ما هو أكثر إلحاحاً وأقرب إلى التجسد في كتابة، أعني الكتابة الروائية”.
بدأ الضعيف مساره السردي برواية “المستبد”. فهل من تفسير لهذه البداية؟ وهل كان الهاجس الجنسي محركاً للراوي، الشخصية الرئيسية في الرواية؟ يجيب: “في الواقع كنت قد أنهيت الجزء الأكبر من الرواية عام 1981، واضطررت إلى ترك المخطوطة في البيت بعد احتدام المعارك في العاصمة، وغارات الطائرات الإسرائيلية على بيروت، ومن ثم اجتياح أول عاصمة عربية، ناجياً بنفسي. ولما عدت إلى المنزل، عام 1982، نفضت الغبار عن المخطوطة واستكملت الرواية، إذ أدخلت إليها هذا المشهد المتخيل – أي الفعل الجنسي التلقائي بين الراوي الأستاذ الجامعي، وبين الطالبة الجامعية في غرفة الناطور تحت وابل قصف الطيران، ومن ثم اختفاء الطالبة. وأنا كنتُ ولا أزال على يقين من أن الهاجس الجنسي لم يكن أبداً هو المستهدف، بقدر ما كان مجرد رد فعل نوعياً للنجاة من الموت المحدق بالشخصين جراء الحرب المحتدمة فوقهما، وانتصاراً للحياة فيهما”.
المدينة المتهالكة
في رواية “تقنيات البؤس” اقترب الضعيف أكثر من واقع المدينة المتهالك، ومن وصف تهشم بنيانها وتقزم الفرد فيها. فما رأيه؟ يجيب: “قال لي الصحافي الراحل جوزيف سماحة، لما قرأ الرواية أنني “اختزلتَ الإنسان فيها، فجعلته متراً واحداً، بل لا يتعدى المتر، على سوية المرحاض: شرب، وأكل، ووسخ. أي يقضي حاجاته الأساسية فقط. هذا ما قاله جوزف”.
أقول له: ربما مثل حالنا اليوم! يقول: “طبعاً. كنا نحفظ الماء، لا نهدره حتى لو كان وسخاً بعد الغسل، لأغراض أخرى. هذا ولم أحدثك عن معاناة التنقل من بيروت، حيث سكني، إلى زغرتا وإهدن، إذ كنتُ اضطر للسفر إلى قبرص من أجل بلوغ شاطئ طرابلس للعودة إلى بلدتي إهدن. الرواية، إذاً، كتبت في هذه الأجواء الضاغطة، بل أكثر. ولكن ما بدا غاية في الأهمية، بالنسبة لي، وما تكشفه الدراسات لاحقاً، أن اللغة التي كتبت بها الرواية كانت شديدة الدقة، إذ لم أستعملْ فيها أفعالاً مجردة، أو يستحيل رؤية حركتها، من مثل (فكر، تذكر، أحس…)، وبالمقابل استخدمتُ أفعالاً تدل على سلوك. وصنعتُ مشاهد يدل كل منها على سلوك. وكنتُ لطالما دعوتُ طلابي وطالباتي إلى الحديث عن الخائن، والمحب، وليس عن الخيانة، والحب، وغيرهما. وأنتَ، كيف لك أن تفهم مخططات العدو إن لم ترصدْ أفعاله! إذاً، السلوك ينبغي أن يتجسد في أفعال. وفي ما خص هذا الأسلوب الذي اعتمدتُه في “تقنيات البؤس” قول للناقد المصري صبري حافظ، في أن لغة الرواية هذه يمكن أن تكون تأسيساً لرواية عربية جديدة”.
في رواية “ناحية البراءة” تمثيل رمزي أو تجسيد رمزي مرعب لتدخل الميليشيات اللبنانية أو الأحزاب المسيطرة على المدينة في حياة البشر، واتهامهم بسوء الظن من خلال حادثة تمزيق صورة الزعيم. المناخ يبدو كافكاوياً بل أعنف منه، فما رأيك؟ يوضح الضعيف هذا الأمر: “ليس اتهاماً بسوء الظن فحسب، بل بالعداء أيضاً! أنت محق ثمانين في المئة. وهذا رأي قال به أحد النقاد التونسيين، منذ زمن في أن لهذه الرواية طابعاً كافكاوياً. ولكن الفارق هنا أن البطل رافض للواقع. ذلك أن الاتجاه الذي يمثله كافكا مأساوي لا خلاص منه، في حين أن اتجاه الرواية عندي درامي، لأن ثمة كوة خلاص تتمثل في التعبير عن رفضه فيها”.
الحرب اللبنانية
أسأله عن رواية “غفلة التراب” التي تحكي عن فترة ظهورات عجائبية، لدى المسيحيين اللبنانيين بعامة، وفي بلدة إهدن بخاصة، بالتزامن مع احتدام المعارك الطاحنة بين أفرقاء لبنانيين (حرب الجبل، حرب التحرير أو الإلغاء، وحروب المخيمات). وتقوم حكاية الرواية على خلطة من السيناريوات والقصص الجانبية، والخوارق، إلى جانب مأساة مقتل اثنين من الشبان الإهدنيين من عائلتين مختلفتين ومتخاصمتين سياسياً، إذ انهالت عليهما الردميات بينما هما يحفران خندقاً لبناء منزل أحدهما، وقد ضمنتَها رؤيتك للحرب الأهلية في لبنان. يتحدث الضعيف عن هذه القضية قائلاً: “يقول ماركس بما معناه “إننا نقاتل بذاكرتنا”. أي بما اختزناه في ذاكرتنا الفردية والجماعية. والحال أن الناس لدينا يعودون إلى رموزهم القديمة حالما يُسد الأفق في وجههم. وأقول في موضع ما من كتابي الشعري “حين حل السيف على الصيف” فلتسقط الذاكرة التي تتذكر”.
رواية “أهل الظل” الموجزة (76 صفحة) هي محاورة شعرية ووجدانية ورمزية في آن واحد بين رجل وامرأة، ينوي الأول بناء منزل له على الصخر، فيتهيأ للمرأة أن ثمة أفعى في أحد شقوق المكان. هل هي حول أسطورة البيت؟ أم حول المنزل الزوجي؟
يجيب: “في هذه الرواية التي أعدت إحدى الطالبات عنها أطروحة دكتوراه، أجمع فيها كائنات الظل، والأفعى من كائنات الظل. العقرب من كائنات الظل. وهذان الكائنان مؤذيان للإنسان. وأنا إذ جعلت الرجل والمرأة يتحابان، ويحلمان بأن يسكنا في ظل منزل يؤويهما، يصيران كائنين مؤذيين، أحدهما للآخر، حالما يصيران معاً تحت ظل المنزل. وقد بات كل منهما على يقين بأنه كلما تقدمت أعمال بناء المنزل، ازدادت المخاطر في تهدم هذا المنزل”.
هل يعني هذا أن الضعيف ضد مؤسسة الزواج التي رمز إليها المنزل؟ يجيب: “لا أقول ذلك. أنا مع علاقة الحب، وأتمنى أن يكون لي امرأة آنس إليها، ولكن هذا ما أعرف به المنزل، أي حقيقته من دون مواربة. ذلك أن غاية الأدب تسمية ما لا اسم له، بحسب رولان بارت. أنا ألقي ضوءاً على الزمن، متجنباً كل ملمح من غنائية”.
علاقات شائكة
رواية “أوكي مع السلامة” تحكي عن علاقة الراوي الستيني بامرأة تدعى “هامة”، مطلقة حديثاً من أميركي، وعائدة لتوها من بلادها. ولكنها سرعان ما تنفصل عن الراوي، وبغرابة. أسأله هل يعتبر أن فكرة اللحظة الجنسية عند المرأة هي المحور؟ أم أن الراوي كان أعجز عن تلبية متطلبات المرأة المعنوية؟ يقول: “إنها رواية تتحدث عن إمكانية تحقيق الحلم، وتحقق الإنسان من عجزه عن ذلك. بل قل هي صدمة الفشل في تحقيق هذا الحلم. إنها دراما أو مأساة شأن أي مأساة إنسانية أن يكون المرء عاجزاً عن الحب. وهذا معروف في الأدب، من جلجامش ونبتة الخلود، إلى القائد الروماني العائد منتصراً في الحرب إلى روما، وينتبه فجأة أن قلبه صار خاوياً من الحب… وصولاً إلى تحفة كواباتا في “الفتيات النائمات” وغيرها”.
في رواية “انسي السيارة” يحضر هاجس تزويج الأب، بعد موت الأم، والعلاقات الجنسية المضطربة بين الرجل المتزوج والفتيات العزباوات، والعشيقات. هل الخشية من البنوة (الحمل) سواء بنوة الأب الأرمل، أم الابن الخائف من المسؤولية المترتبة عنه، تبلغ حد الهستيريا؟ أم هي براعة الأنثى، جميلة كانت أم قبيحة، هي المقصود إبرازها؟ يتحدث الضعيف عن مثل هذا الهاجس المزدوج قائلاً: “كتبتُ هذه الرواية وأنا متخفف من كل خلفية فكرية أو أيديولوجية. على كل، لا تخلو رواية مما كتبتُ من لطشة ضد الأيديولوجيا السائدة، يميناً ويساراً. والخفة المقصودة هي الحرية من كل قيد فكري مسبق. فأنا أعظم من عاش. وأنتَ أعظم من عاش. أما القضايا فقتلتنا. ولم يبقَ من العرب إلا قضاياهم، على قولة أحدهم”.
يقول رشيد الضعيف إن لديه صنفين من الروايات، دنيا وفصحى. فماذا يعني بهما؟ يقول: “إن روايتي الدنيا هي ضد الرواية الفصحى. الرواية الدنيا هي التي أسعى فيها إلى تبيين الواقع كما هو، وباللغة اللازمة لوصف الواقع، والأشخاص، والنواقص، والعقد المخبوءة في النفوس، من دون مراعاة للأذواق أو التراتبيات الاجتماعية والتابوات وغيرها. فعلى سبيل المثال، أكاد أكشف، في روايتين لي هما “خطأ غير مقصود” و”ألواح” عن ظواهر اختلال في سيرتي، علاقة أمي الفتاة الجميلة والبسيطة والأمية التي تزوجت بأبي ويكبرها بثلاث عشرة سنة، وتنشغل معه بإكثار نسله، بثماني أبناء وبنات، ولا ينشغل أحدنا ساعة واحدة لتعليمها حرفاً ومحو أميتها، وجعلها توقع اسمها أقله! كما أني لا أرى مانعاً من الذهاب إلى الكشف والفضح، في هذه الروايات الدنيا. والخير في الفضح أنه يكشف عن زيف الصورة بل الصور المثالية الكاذبة عن العلاقات والقرابات، والعقد المتحجرة في العقول والمتجسدة في سلوك البشر وأفعالهم. في حين أن كل روايات نجيب محفوظ تنمى إلى الفصحى، أي أنها روايات تعلو مقاماً عن هموم الناس وقضاياهم الحقيقية. وأحسب أن للروائي الحق في تمتين لغته الروائية، ولكن ليس بالكثافة التي يسعها أن تكون قناعاً إضافياً مانعاً من كشف حقيقة الشخصية وفعله”. يبدو هذا التعريف أشبه بتصنيف المسرح قديماً، على ما تناهى إلينا من أرسطو: مسرح أعلى وأدنى، ولكن مع اختلاف النوع الأدبي.
أياً يكن، ثمة وجوه للمرأة في روايات الضعيف؛ العاشقة، والمبادرة والمطلقة المنفتحة والمبدعة، والأم. اسأله عن الأم في العديد من رواياته، فيقول: “في البداية أحب، بل أحببتُ أمي كثيراً، واسمها الحقيقي ياسمين. ولكن الأم، أياً تكن، تحمل في ذاتها جراثيم تنشئتها الأولى. فهي لم تعلمنا أن نكون مواطنين في دولة، ولم تعلمنا أموراً كثيرة. لذلك على الكاتب أن يضع الأمور في نصابها. ولهذا رأيت لزاماً علي أن أتخذ موقفاً نقدياً من الأم، من أمي أولاً ومن سائر الأمهات العربيات اللواتي يورثن أبناءهن وبناتهن لوثة التمييز الطائفي والديني والطبقي والأخلاقي. وتغيظني رؤية أحدهم مداهناً ومادحاً أمه، ومغنياً لها أناشيد على التلفزيون، باكياً رحيلها أو بعادها. هذا حبل السرة اقطعوه بقى! في رواية “ألواح” مشهد مؤثر؛ الأم تبدي لابنها الراوي (أنا) رغبتها في تعلم الكتابة، فيجيبها قائلاً: ألا يكفي أن تكوني أمي؟ كانت أمي تبصم، ولم يخصص لها أحد من أبنائها وبناتها الثمانية وقتاً لكي تفك الحروف. أما والدي فبالكاد كان يفك الحروف، ويوقع باسمه. مات شاباً بالسكتة القلبية عن عمر التاسعة والأربعين، وكان اسمه بولس”.
اللغة الإنجليزية
في مقال بحثي عالجت الناقدة الأكاديمية كاتيا غصن (بالفرنسية) مسألة تعلم اللغة الإنجليزية في روايات الضعيف، وقد كانت موتيفا في روايات مثل: “عزيزي السيد كواباتا”، و”ليرننغ انغلش”، و”أوكي مع السلامة”. أسأله: هل تود القول إن اللغة الإنجليزية باتت عنواناً للتميز الاجتماعي، مضافاً إلى عناوين التميز الطبقي والطائفي والجندري وغيره في البلاد؟ يجيب: “أكيد! إن لم تعرف الإنجليزية تُستبعد. حتى أهالي الأشرفية باتوا مقتنعين بضرورة التحول إلى تعلم اللغة الإنجليزية. ولكن وظيفة الإنجليزية في كل رواية مختلفة عن غيرها. فعلى سبيل المثال، كان سعي الراوي إلى تعلم الإنجليزية، في رواية “أوكي مع السلامة”، من أجل فهم حبيبته “هامة”، وإدراك رغباتها العميقة، من خلال تفاعله مع الأفلام التي تهواها. ثم إن الإنجليزية هي لغة الترقي الاجتماعي، ولا يمكن المرء أن يكون أدنى ثقافة ممن يحب، ولا أن يتقوقع في عالمه، في حين أن عالمها منفتح على الآفاق اللامتناهية”.
كرس الضعيف رواية “تبليط البحر” المستندة إلى التاريخ، لإبراز شخصيتين معروفتين من كتاب النهضة، وهما جرجي زيدان، وأحمد فارس الشدياق، على رغم الفارق الزمني بين الشخصيتين. أسأله “إلام انتهيت فيها؟ يقول شارحاً: “لما انصرفت إلى كتابة الرواية، لم يكن في خاطري سوى جرجي زيدان، من دون أحمد فارس الشدياق. أما الدافع إلى صوغ هذه الرواية المستعار شخصها ومكوناتها من تاريخ ليس بالبعيد -بحدود مئة وثلاثين عاماً- فهو عزمي على إظهار اندفاع المثقفين اللبنانيين لبناء الدولة الحديثة من خلال محورين كبيرين هما، الصحة والتربية. وهذان المحوران عمل عليهما البروتستانت، إذ كانوا السباقين إلى بناء أول كلية للطب في المشرق العربي في ما سمي بالكلية الإنجيلية السورية في بيروت. وقد لحق بهم اليسوعيون عام 1875، فأنشأوا جامعة القديس يوسف. ولكن النهاية المأساوية للرواية، أي موت الطبيب فارس شاباً وعودة جثمانه إلى مرفأ بيروت، من دون أحلامه في نهضة وطنه وتحديثه، على غرار أوطان الغرب التي عاين جبروتها، إنما تشير إلى فشله، وفشل المثقفين من زملائه، في بناء وطن حديث”.
وبالعودة إلى روايته الصادرة حديثاً “الوجه الآخر للظل”، أسأله: كيف تفسر ظاهرة عودتك إلى الأسطورة والأحداث الخارقة، بما يشبه “ألف ليلة وليلة” وأسطورة سيف بن ذي يزن، وغيرهما؟ وبم تعلل ظاهرة المرأة-الملكة ذات القدرات السحرية والأفعال الخارقة، هي وابنها “عديا”، وتواصلهما مع الكائنات الطبيعية؟ ألا ترى تشابهاً بين الملك في الرواية وشخصية شهريار في “ألف ليلة وليلة”؟ يفسر الضعيف هذا الأمر قائلاً: “لقد جعلتُ من الملك في رواية “الوجه الآخر للظل” شخصية نموذجية مستفادة سماتها من كل ما عرفته عن علاقات الرجل بالمرأة، في التاريخ، شرقاً وغرباً. ثم ألم ترَ هذا الملك لم يتورع عن قتل أخته لأنها أحبت رجلاً لم يكن ليرضى عنه؟ وإن يكن الملك في الرواية يعمد إلى قتل بعض النساء اللواتي لم ينجبن له أو اللواتي أنجبن له، فإن هذا الفعل (القتل) قاسم مشترك مع شهريار. ثم لا تنس أنني أستند، في ما أصوغه من نماذج، إلى التراث العربي برمته. وهو الذي خولني أن أبقي على سمات الرجل العربي، وآخذ على عاتقي صوغ صورة الملكة-المرأة المضطهدة، ولكن العليمة، والراقية، والسلمية المنحى، والخارقة القدرات، ومربية الأبطال”.






