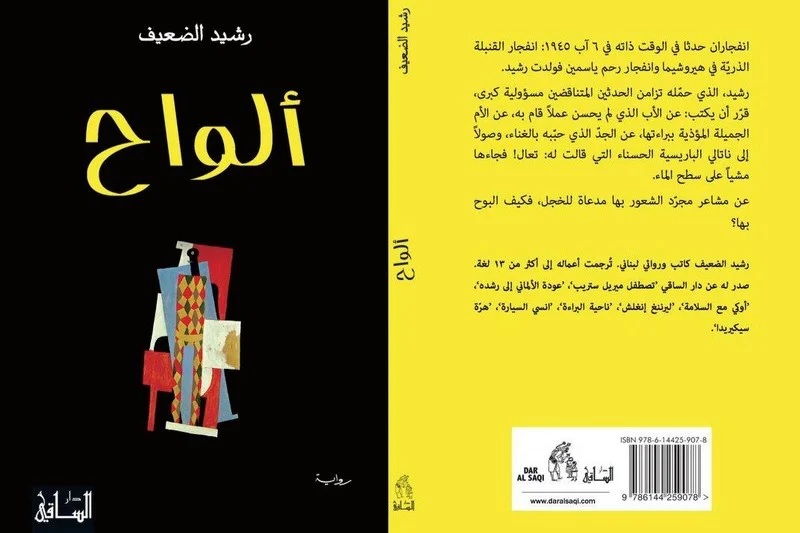
يربط الجامعي الفرنسي فيليب لوجون في كتابة “الميثاق السيرذاتي” بين أدب السيرة الذاتية وصعود طبقة مهيمنة جديدة هي البورجوازية. يلاحظ قارئ “ألواح” أن رشيد الضعيف لا يتفق تماما مع لوجون عندما يكتب ما يمكن أن نسميها سيرته الذاتية وهو القادم من وسط اجتماعي متواضع بعيد عن “التبرجز”. تصنف صفحة الغلاف “ألواح” ضمن جنس الرواية، لكن الضعيف يعترف في أحد حواراته التلفزية بأنها سيرة ذاتية، فيها الكثير من الذات، ويمكن أن نضعها تحديدا في خانة “التخييل الذاتي” الذي يسمح له بأن يكتب بحرية أكبر مما تتيحه السيرة الذاتية التقليدية، لأنه يمكّنه من سرد الأحداث التي وقعت بالفعل وتلك التي كان يمكن أن تقع.
رجل لا تليق به السيجارة، قوي الشخصية، يعرف نفسه جيدا، يخطط لمشاريعه بشكل دقيق وينفذها بدقة أكبر.. هكذا ينظر بعض المعارف إلى رشيد.
هل هم على حق؟
بين نظرة الآخر وتمثّل الأنا ..
يجيب الضعيف قطعا: لا.
مدخن شره يدخن ما يقارب ثلاثين سيجارة في اليوم، يخطط منذ خمس وأربعين سنة للتوقف عن التدخين دون أن ينجح في تنفيذ مخططه، مصاب بأرق حاد يمنعه من الاستمتاع بمتعة النوم، مصاب بالخيبة من السياسة وعالمها، فاشل في العلاقات الإنسانية.. هكذا يقدم الكاتب/ السارد نفسه.
ارتبطت أول أزمة هوية عاشها الضعيف باسم العائلة، اكتشف بعد أن دخل المدرسة أنه يملك إلى جانب اسمه الشخصي اسما عائليا: “الضعيف”، اسم قد يستعمله زملاؤه الصغار ضده لإسكاته أو للحد من قوته، هنا تبادر السؤال إلى ذهنه:
” ماذا فعل بي والدي؟”
طرح رشيد الطفل السؤال الذي طرحه كثير من الناس – صغارا وكبارا- بعد أن اكتشفوا أن عقول آبائهم أو أجدادهم كانت غائبة أو مغيبة لحظة الاختيار. لم يكن اسم العائلة مصدر إزعاج لرشيد الصغير فقط بل حتى للأستاذ البالغ المدرّس في الجامعة حين لاحظ ابتسامات الطلاب الذكور عندما قدّم نفسه في أول لقاء بهم. هنا فهم طلاب الجامعة الماكرون ما لم يفهمه تلاميذ المدرسة الأبرياء.
يلاحظ القارئ أن الكاتب أجّل الحديث عن ولادته وحيثياتها إلى نهاية الكتاب في فصل عنونه بـ”أنا وهيروشيما” مكسرا بذلك خطية الزمن وقواعد الكتابة السردية التقليدية، فما يهم الكاتب ليس الالتزام بتقاليد الكتابة وأدبياتها وإنما البوح بأكثر ما يمكن قوله، متحديا بذلك الفكرة التي تقول إن الكتابة عن الذات إذلال للنفس.
حكي الفقر
ولد الضعيف فوجد نفسه ينتمي إلى أسرة اختارته ولم تترك له فرصة أن يختارها، أسرة فقيرة تعيش على الهامش: الوالد حلاق بسيط، الوالدة ربة بيت هدّها الزمن، الإخوة سبعة، البيت قبر من غرفتين مساحته لا تتجاوز أربعين مترا، المرحاض في البيت ترف لا تستعمله سوى الأم المقهورة بينما يتخذ الباقون من الخلاء فضاء لقضاء مآربهم، فرشاة الأسنان سمع بها الإخوة ولم يحلموا بامتلاكها.
يعترف السارد بأن الأكل في طفولته كان عزيزا فكان يأكل – بتوجيه وإلحاح من الوالدة- البيضة الواحدة بكثير من الخبز، كان هم الأم المسكينة أن يشبع ابنها الجائع فيتوقف عن البكاء، ولم تكن تضع في حسبانها حساب عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يتناولها صغيرها كما تفعل أمهات الطبقة الوسطى في أيامنا هذه.
وعلى الرغم من كل هذا، يحكي الضعيف أن رشيد الصغير كان سعيدا يعيش اللحظة لذاتها ويستمع بها ناسيا إكراهات الانتماء السوسيولوجي والجغرافيا، لأنه لم يع بعد حقيقة وضعه الاجتماعي… سيتكوّن هذا الوعي بفعل التعلم والمدرسة، لتبدأ مرحلة الشقاء والأمراض النفسية.. يكشف الضعيف هنا عما سبق أن أدركه المتنبي وغرد به أمام الناس قبل زمن بعيد.
أقرأ الصفحات الأخيرة من الكتاب فأكتشف أن وضع رشيد لا يختلف عن الصورة التي رسمها لوالده: عينان مطفأتان، نفسية مأزومة.. الفرق بينهما أن الوالد مات سعيدا.هل استطاعت الكتابة أن تعالج نفسيته؟
الظاهر: لا.
أتأمل قولة فيليب لوجون: “الحديث عن الذات يمكن أن يفيد إما كبرياء متضخمة.. وإما نوعا من التواضع”، فأميل إلى القول إن حديث الضعيف عن ذاته في هذا العمل يفيد التواضع أكثر من الكبرياء. الكاتب يسلط الضوء على عيوب الذات أكثر مما يركّز على منجزاتها.
السادية..بين الاعتراف والنفي
يحكي الضعيف عن هوايات طفولته التي يتفرغ لها في فصل الصيف، يصفها بكثير من الحنين.
إليكم بعض هذه الهوايات:
تعذيب الحيوانات وقتلها، رمي الكلاب بالحجارة، صيد الضفادع وتمزيقها حية إلى نصفين، قتل الصراصير والنمل، صيد الذباب والتنكيل به بنزع جناحيه ثم قوائمه، صيد السلاحف وعقرها أو سلقها حية لبيع هيكلها…في وصفه لهوايات طفولته ولاستمتاعه بممارستها يظهر جانب من السادية في شخصية رشيد الطفل، سادية لا يمكن نفيها حتى عن شخص الضعيف الراشد الذي يعترف بأنه لا حب يعلو على حبه قتل البرغشة، وبأنه يحتفظ ببقع دمها على الحائط فوق السرير مباشرة ويرفض إزالتها لأنها تولد متعة في نفسه، حتى إن الصباغ المسكين الذي جاء لإعادة صباغة البيت أصيب بالدهشة عندما طلب منه أن يترك مكان بقع الدم دون صباغة.
كتبرير لهذا الميل، يحكي الضعيف أنه ورث هذه الصفة عن أمه التي كانت تكره الطيور والحشرات والحيوانات وترفض وجودها في البيت.
يظهر السارد وهو يحاول أن يبعد عنه تهمة المرض النفسي/ السادية حين يصرخ أنه ليس مجنونا، ويكره أن يتصرف معه أحد على أنه كذلك لكنه فقط يكره البرغش. وهو يحاول أن يبعد التهمة يظهر أنه على وعي تام بمشكلته النفسية.
هل المرأة مصدر إلهام أم إحراج؟
تحضر شخصية الأم بشكل قوي في الرواية/ السيرة، يتذكر رشيد أمه شابة رجّها الزمن لكن ظلت قوية وصبورة، تزوجت وعمرها ثلاث عشرة سنة رجلا معدما يكبرها بكثير.
وإذا كانت الوالدة هي من تلد والأم هي من تربي وتحن وتعطف فإن والدة الضعيف تجاوزت مرتبة الوالدة لتستحق لقب الأم في زمن كثرت فيه الوالدات وقلت الأمهات. وأم رشيد امرأة لم تأكل في مطعم طوال حياتها إلا مرة واحدة، ولم تشرب فنجان قهوة إلا بالصدفة النادرة عكس كثير من أمهات أيامنا المنحدرات من الطبقة الوسطى اللواتي يهربن من البيت ومطبخه في أول فرصة تتاح لهن ويهرولن نحو أقرب مطعم مصطحبات أولادهن المساكين. أم رشيد سيدة أمية لم تقرأ في حياتها كتابا ولا مجلة ولا إعلانا ورغم ذلك استطاعت أن تربي ثمانية أبناء في زمن غير بعيد عن زمن تعجز فيه الوالدات المستحدثات عن تربية طفل أو طفلين.
وعلى الرغم من تعلقه بأمه، لا يخفي الضعيف غضبه منها لأنها ورثته البراءة في عالم يسوده المكر والعنف والظلم؛ غضب لم يمنعه من الحزن على موتها، ما جعله يرى بيت الأسرة بدون الأم “جوف كوكب بدون جاذبية”.
ويتذكر الضعيف كثيرا “ناتالي”، الشابة الفرنسية المتحررة التي تعرّف إليها في باريس بعد طلاقه مباشرة. تحول التعارف إلى علاقة – اعتبرها هو حارة عاصفة- دامت لزمن قصير قررت بعده الشابة بشكل مفاجئ قبول عرض عمل لا يتكرر في نيويورك سمّته “عرض العمر”. فضلت الشابة مستقبلها على قلبها.
دفعت العاطفة الضعيف إلى اللحاق بناتالي في نيويورك، أحس بالتيه عند وصوله إلى أمريكا بسبب عجزه اللغوي: شعر بالغربة منذ أن دخل مطار لبنان، اكتشف أن لغة العصر هي الإنجليزية وأن جميع لغاته ولهجاته لا تنفعه في شيء. بعد وصوله إلى نيويورك، يبوح لنا الضعيف بمشاعر يعتبر في غلاف كتابه “مجرد الشعور بها مدعاة للخجل”، اعترف بأنه كان ينتظرها في شقتها ليلا وهو يعلم أنها كانت مع رجل آخر، قبل بهذا الوضع وهو الشرقي الذي تعدى الأربعين من عمره والذي كوته الحياة ما يكفي ليدرك حقيقتها.
اكتشف رشيد أن ناتالي ليست لعربي من جبل لبنان، وأن فكرته عن العلاقة لا تختلف أبدا عن فكرة والده الذي انتقده صغيرا واحترمه كبيرا: أن تكون امرأته له.. وانتهى الموضوع.
تفسخت علاقة رشيد بناتالي، اصطدمت سذاجة الشاب البدوي اللبناني ورومانسيته المصطنعة بتحرر الفتاة الفرنسية المدينية وعقلانيتها وبراغماتيتها الجامحة. وقع رشيد في فخ البراءة والسذاجة الذي حاول دائما تجنبه: فشل في تحويل الوعي بمشكلته إلى سلوك، ظل رومانسيا بريئا أمام شابة آمنت بمبدأ الحرية وتشربت فكر الأنوار.
اختار الضعيف أن يستعمل في حديثه عن المرأة ضمير المتكلم، وهو اختيار يجعله جريئا في البوح في نظر فيليب لوجون الذي يرى أن مؤلف السيرة الذاتية قد يستعمل “ضمير الغائب ليتخذ مسافة حشمة من بعض مراحل حياته”. صحيح أننا هنا بإزاء تخييل ذاتي، لكن عنصر الذاتية يبقى حاضرا فيه بشكل قوي.
الحرب: لعنة أدمنها اللبنانيون
اندلعت الحرب الطائفية اللبنانية سنة 1975 ودامت خمسة عشر عاما وتسببت في عدد هائل من القتلى والجرحى والندوب في أجساد البشر ونفوسهم. يتحدث الضعيف عن هذه الفترة والمرارة تعصر قلبه، يحكي كيف جُرّ إلى هذه المعركة قسرا بعد أن نُسب إليه كلام يفيد أن المسلمين في لبنان يضطهدون المسيحيين، وهو المسيحي اللبناني الذي تفادى مرارا أن يصب مزيدا من الزيت فوق نار ملتهبة. أصيب رشيد في هذه الحرب بشظايا قنبلة فسرق العابرون ما كان معه، نقل إلى المستشفى فاكتشف أن الطبيب “العدو” حاول أن يعطيه دما فاسدا لكن الصدف شاءت أن يأخذ دما صالحا؛ فهم فجأة أنه يعيش في دولة مؤسساتها لها هيئة المؤسسات لا عملها، ومستشفياتها يمكن أن تخرج منها جثة ميت دون أن تعلم الإدارة بالخبر.
في زمن الحرب الأهلية لم تعد لبنان مكانا صالحا للعيش، صارت بلدا تحكمه الميليشيات، تحول المُقاتل في خضم الحرب إلى سيد الليل والنهار، يدخل بيوت الناس متى شاء ومن أين شاء. لتجري اتصالا هاتفيا وجب عليك أن تنتظر في طوابير طويلة لساعات.. أصبح الأفق مسدودا بفعل هذه “الحرب اللعينة التي أدمنها اللبنانيون وجيرانهم”.
ختاما
يرى الكاتب الفرنسي أندري جيد أن السيرة الذاتية لا يمكن أن تكون إلا “نصف صادقة.. بل ربما تقترب الحقيقة أكثر في الرواية”، ويوافقه مواطنه فرنسوا مورياك الرأي عندما يقول “إن التخييل هو وحده الذي لا يكذب”. ربما هذا هو المنطق الذي جعل رشيد الضعيف يختار أن يكتب تخييلا ذاتيا وليس سيرة ذاتية تقليدية. لعل مآزق السيرة الذاتية هي التي تجعل الكاتب يهرب نحو التخييل. على الرغم من هذا يبدو أن رشيد الضعيف قد نجح في إيهام القارئ بأنه يحكي دائما قصته الذاتية ليشبع لديه بذلك متعة قراءة القصة ومتعة التلصص على الحياة الخاصة لكاتبها. نجح الضعيف في الكتابة عن الذات بجرأة وهو ابن الثقافة العربية التي سبق أن وصفها بأنها “ثقافة الأمكنة العامة”، حيث يستطيع المؤلف أن يكتب فقط ما يمكن أن تقرأه ابنته أو زوجته أو أخته، وحيث “نادرا ما نعترف بأن الشيطان فينا”.






